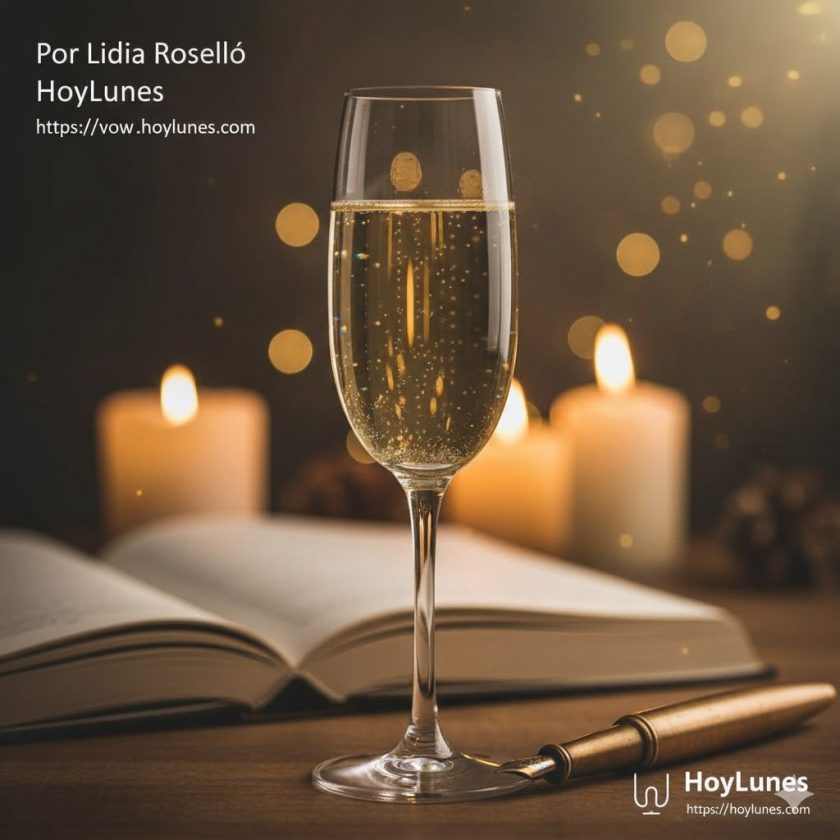تستيقظ إسبانيا على جرحٍ صامتٍ يخترق الفصول الدراسية والمنازل والشاشات. لا يكفي أن نحمي أنفسنا؛ يجب أن نفهم ونعالج ونُثقّف من جذور المشكلة. تغيير التركيز لا يعني غضّ الطرف، بل أن ننظر بعمق.
بقلم السيدة بيلار رويدا ريكينا
Hoylunes – على الرغم من أننا نسمع منذ زمنٍ طويل – وإن لم نُنصت بصدق – عن حالات التنمر المدرسي، إلا أننا لم نشعر حقًا بالصرخة والخوف والحاجة الجماعية المُلحة للصراخ “كفى!” كصرخةٍ من المجتمع ككل إلا في الأسابيع الأخيرة، عقب انتحار فتاة صغيرة مأساويًا ثم حالة أخرى مُماثلة.
ولكن… هل نعرف حقًا ما نواجهه؟ ما الذي يُسبب هذا السلوك لدى أولئك الذين يُسببون كل هذه المعاناة للأطفال الآخرين وعائلاتهم؟
إنه شكل من أشكال عنف الأقران – مُتعمد، ومتكرر، ومُمتدّ على مر الزمن. قد يتجلى هذا العنف جسديًا أو لفظيًا أو نفسيًا، بقصد الإيذاء أو بثّ الخوف أو الإقصاء.
أمام هذا، علينا أن نسأل أنفسنا: لماذا قد يستمتع شخص ما بمعاناة شخص آخر إلى هذا الحد؟
تختلف سمات المعتدين: من شخصيات مهيمنة أو عدوانية إلى شباب ذوي تقدير ذاتي متدنٍّ يسعون إلى نيل التقدير الخارجي. يسعون إلى جذب الانتباه من خلال العنف، وغالبًا ما يتصرفون بدافع انعدام الأمن. في كثير من الحالات، يُعيدون إنتاج سلوكيات يلاحظونها في بيئاتهم العائلية أو الاجتماعية.
في نهاية المطاف، الأنا هي التي تُحرك سلوكهم – سواءً من خلال الخوف أو الكبرياء أو الإحباط أو الغطرسة – مُظهرين بذلك ضيقًا داخليًا لا يعرفون كيفية التعامل معه.
إلى هذه العوامل المتعددة، يُضاف القلق الناجم عن عدم اليقين بشأن المستقبل، والذي يُميزه تغير المناخ وانعدام الأمن والخوف المنتشر عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. غالبًا ما يفتقر المراهقون، الذين لا يزالون في خضم نموهم العاطفي، إلى الأدوات اللازمة لتصفية أو تفسير هذه الرسائل بشكل صحيح.
من ناحية أخرى، يميل المراهقون الذين يعانون من آثار التنمر إلى مشاركة بعض السمات، وإن كانت تُعبّر عنها بشكل مختلف: ضعف الثقة بالنفس، والخجل، أو الانطواء، وكلها عوامل تزيد من ضعفهم. ومع ذلك، قد يمتلكون أيضًا مواهب أو صفات – كالجمال، أو الذكاء، أو المهارات الاجتماعية – تثير الحسد أو الاستياء لدى المعتدي، تحديدًا لأنهم يجسدون ما يفتقر إليه المعتدي.

منظور جديد للتنمر
هذا ما أودّ التركيز عليه: علينا تغيير منظورنا وتوجيه اهتمامنا ليس فقط لمن يعانون من الأذى، بل أيضًا لمن يُلحقونه.
لسنوات، ركّزت سياسات مكافحة التنمر على حماية الضحية، لكن هذه الحماية الأحادية، وإن كانت ضرورية، قد يكون لها أثر عكسي: فهي تُعزز خوفهم وشعورهم بالعجز.
في الوقت نفسه، ينظر المعتدي إلى هذه الإجراءات على أنها انتصار، معتقدًا أنها حققت هدفها: الإيذاء ولفت الانتباه.
تحويل التركيز يعني تجاوز العقاب. يجب أن نتصرف بتوازن وعمق: معالجة السلوك العدواني، ومعالجة جذوره العاطفية والعائلية أيضًا.
قد يكون الفصل الجسدي بين المعتدي والضحية إجراءً مؤقتًا، ولكنه ليس كافيًا. حتى طردهم من المدرسة قد يبدو تحريرًا، وليس تأديبًا.
لهذا السبب، سيكون من الأكثر فعالية استبدال العقاب ببرامج علاجية تساعد الشاب على إدراك مشاعره، وتحديد سبب غضبه أو إحباطه، وتعلم كيفية توجيهها – بمشاركة أسرته. حينها فقط يمكن بناء تغيير حقيقي ودائم.
يجب أن نغير منظورنا للشفاء والتثقيف. أولئك الذين يعانون من العدوان، أفضل أن أسميهم أبطالًا أو بطلات، لا ضحايا. كلمة ضحية تُضعف – إنها تثير السلبية والألم.
الضحية: ضعف، سلبية، شخص مُقدّر للتضحية (وفقًا لـ RAE).
البطلة: على النقيض من ذلك، تعني الشجاعة والقوة والشجاعة والقدرة على مواجهة الشدائد والتغلب عليها.
عندما يدرك شخصٌ يعاني من التنمر أن المعتدي يتصرف بدافع انعدام الأمن أو تدني تقدير الذات، تتغير نظرته. إذا رغب المعتدي فيما يمتلكه الآخر – الذكاء، أو الجمال، أو المرونة، أو القبول الاجتماعي – فإن فهم هذا النقص في الآخرين يعزز تقديره لذاته.
وهكذا، يتوقف عن الشعور بأنه ضحية، ويصبح بطل حياته، كما ذكرتُ في كتابي “حياتي بأجنحة من ألوان”.
مثالٌ يُغيّر: نادي الشجعان
من الأمثلة الجيدة على كيف يُمكن لتغيير التركيز أن يمنع التنمر هو “نادي الشجعان”، وهي مبادرة تُعلّم الأطفال، من المرحلة الابتدائية فما فوق، كيفية تحديد سلوكيات التنمر والتصرف بتعاطف وشجاعة.
الشجاعة المشتركة تُحوّل المارة إلى أبطال، والضحية إلى بطل قصتها الخاصة.
العملية بسيطة وتعليمية: عندما يتعرض صبي أو فتاة للعدوان، فإن خطوتهم الأولى هي وضع حدود واضحة: “توقف، لا تستمر، أنا أفعل ذلك”.
لا يعجبني الأمر.” إذا لم يتوقف المعتدي، يُبلغ الضحية أو أي زميل شهد الحادثة المعلم، الذي يجب أن يستجيب بانفتاح وحماية.
في هذا النهج، لا يوجد خوف أو صمت، بل شجاعة وتقدير كقيم مُعترَف بها.
بمجرد التحقق من الحقائق، يُعاقب المعتدي فورًا: يوم واحد بدون مشاركة في الألعاب – إلا إذا قررت مجموعة الصف منحه فرصة ثانية.
يُعزز القرار الجماعي التأمل والتعاطف. إذا قرر الصف عدم إعادة الدمج، يُنفذ الطالب عقوبته بتوجيه من المعلم لتشجيع التأمل الشخصي.
حتى لو استفسر طلاب آخرون من خارج المجموعة عما حدث، فإن زملاء الصف أنفسهم هم من يشرحون، متجنبين الشائعات ومعززين المسؤولية المشتركة.
الدرس الرئيسي واضح: الشجاعة في التعبير عن الرأي، والتضامن بين الأقران، والتعاطف مع الآخرين هي ما يستحق التقدير حقًا. بهذه الطريقة، تُكسر دوائر الصمت والتواطؤ التي تُغذي التنمر.

خطط الوقاية من التنمر في المدارس ضرورية، ويجب أن تُشرك المجتمع التعليمي بأكمله: المعلمين والأسر والطلاب.
ومع ذلك، بمجرد وقوع العدوان، من الضروري أيضًا اتخاذ إجراءات ضد المعتدي، من خلال تدابير تكوينية وإصلاحية.
يجب أن يفهم الطفل الذي يعتدي أن لأفعاله عواقب وخيمة، ويجب أن يشعر المتضرر بأنه مسموع ومدعوم ومحاط بالتضامن.
إذا اقتصرنا على الحماية فقط، دون معالجة جذور المشكلة، ستبقى الضحية معزولة والمعتدي مُبررًا.
في كل من التنمر والعنف القائم على النوع الاجتماعي، غالبًا ما ينصب تركيز التدخل على الشخص الذي يعاني، بينما يظل المعتدي بلا عقاب حتى يصبح الضرر لا رجعة فيه.
لا بد أننا نرتكب خطأً ما، لأن هذا العنف – على الرغم من التقدم التشريعي – لا يزال غير متجذر.
من الضروري اتخاذ تدابير واضحة وفعالة، لأن التنمر اليوم قد يصبح مضايقة (تحرشًا أخلاقيًا) غدًا، حيث يشترك كلاهما في نفس الأنماط السلوكية، التي تتكيف وتتطور وفقًا للظروف. والأشخاص المعنيين.
عبّر ألبرت أينشتاين عن ذلك بوضوح:
“لا يمكننا تغيير الأمور إذا استمرينا على نفس المنوال”.
يجب أن يتجاوز التعليم التدريس الأكاديمي: يجب أن يُعزز المشاعر والأخلاق والتعاطف.
فقط من خلال تعزيز قيم كالتواضع والتعاون والوحدة – والوعي بأننا جميعًا مترابطون – يمكننا بناء مجتمع أكثر تعاطفًا.
يجب أن نغرس في الأجيال الجديدة ترياق الأمل: حيث يوجد الأمل فقط يمكن أن توجد الحياة، ويجب أن يصبح شبابنا رُعاة هذه الحياة في المستقبل.

,hoylunes, #m.ª pilar_rueda_requena#